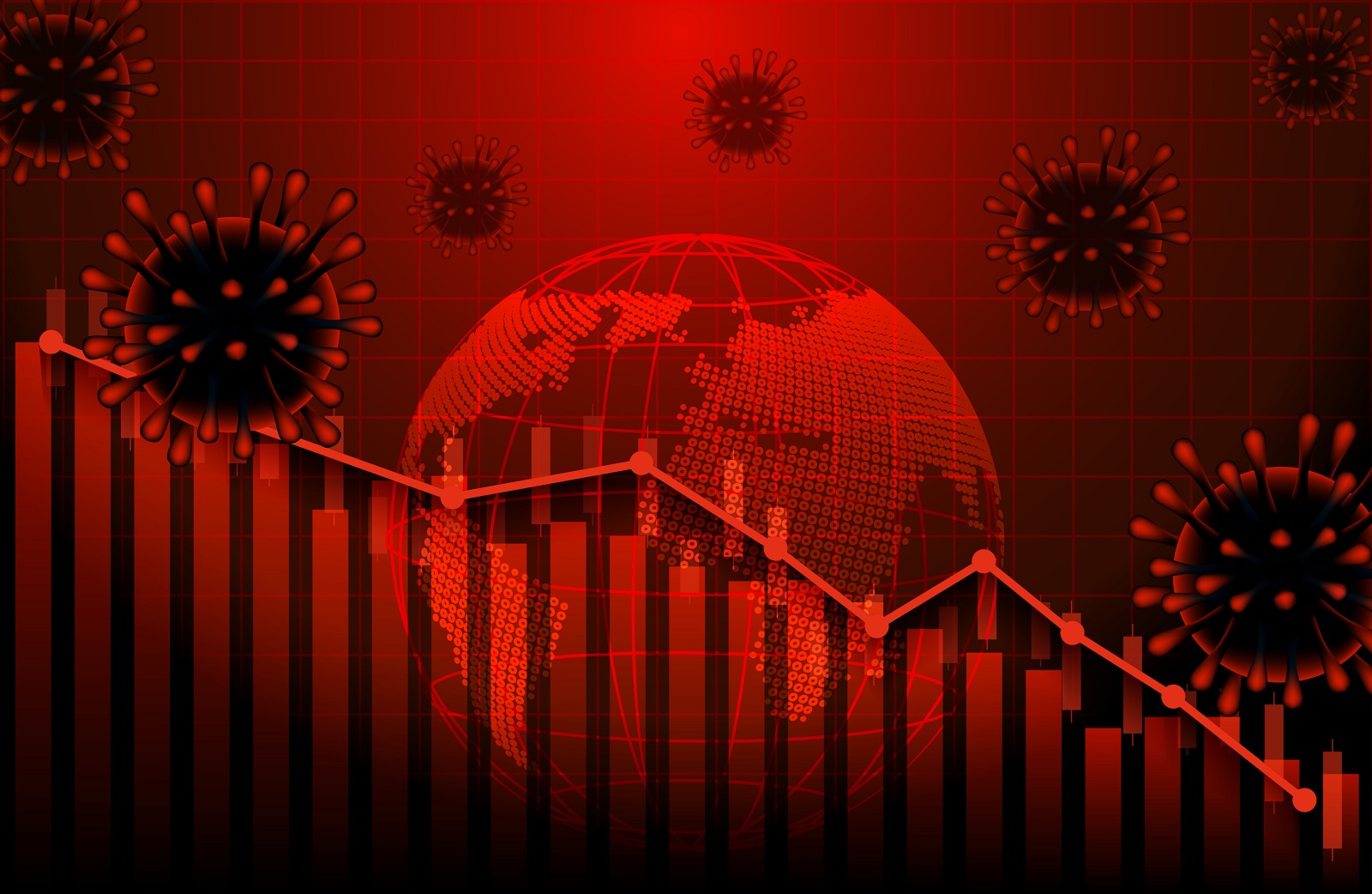حملت أزمة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية، نتيجة حالة الإغلاق العام الكبير، كما يطلق عليها صندوق النقد الدولي، الكثير من التحديات بالنسبة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط، كالانكماش، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الإنتاج والتصدير، وإضعاف الأسس المالية والنقدية، وتضرر موازين المدفوعات، وغيرها. ويمكن الاطلاع على هذه التحديات بإسهاب في التحليل المنشور تحت عنوان "تسطيح المنحنى: كيف تتأثر اقتصادات الشرق الأوسط إذا استمرت أزمة كورونا؟".
والأمر الذي سيتم التركيز عليه في هذا الموضع هو الكيفية التي يمكن لاقتصادات المنطقة التعايش مع جائحة كورنا من خلالها، ومن ثم التأقلم مع تبعاتها الاقتصادية المعقدة لفترات طويلة، ويعود تناول هذه القضية من ذلك المنظور إلى أنه لا يوجد أفق واضح لانتهاء أزمة كورونا، وأن هناك بوادر في الأفق لحدوث موجة ثانية من الإصابات الجديدة بالفيروس، الأمر الذي يُهدد بحدوث أحد أمرين؛ فإما أن تنحو الدول إلى تمديد الإغلاق الاقتصادي بمستوياته الحالية، أو تعود إلى تشديد سياسات الإغلاق إلى أن تنتهي مخاطر الموجة الثانية.
وأي من الاحتمالين من شأنه تمديد أجل الأزمة، وتأجيل تعافي الطلب الاستهلاكي العالمي، لا سيما وأنه لا يمكن الجزم بعدم إمكانية حدوث موجات أخرى، ثالثة ورابعة، لجائحة كورونا، وهو أمر متعارف عليه في علم الأوبئة، بل إنه وفي بعض الأحيان، تكون الموجات اللاحقة أخطر وأشد إيلامًا من الموجات السابقة، كما حدث في وباء الأنفلونزا الإسبانية عامي 1918 و1919، حيث كانت موجته الثانية أخطر من الأولى.
وبافتراض أن هذا السيناريو، وهو الأسوأ بطبيعة الحال، هو الذي سيحدث للجائحة الحالية، فإن ذلك سيدفع الدول إلى تشديد الإغلاق الاقتصادي، وتمديد آجاله، ويقود الاقتصاد العالمي إلى حالة من "الكساد الممتد". وهنا يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا هو: كيف تتأقلم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مثل هذه الحالة؟
تكلفة الأزمة:
إن تعافي أي اقتصاد من أزمة ما، يكون مرهونًا بعوامل عديدة، وعادة ما تكون قوة التحمل الداخلي للاقتصاد هي العامل الحاسم لتعافيه، وهذا الأمر ينطبق على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط. لكن ولأن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي ذات أبعاد عالمية معقدة، ولها تبعات سلبية على حركة البشر والتجارة ورؤوس الأموال؛ فإن الأمر يصبح مختلفًا، لما لسيولة وسيرورة حركة تلك العوامل من أهمية كمقومات لنمو اقتصادات المنطقة، نظرًا لاعتماد معظمها على الإيرادات القادمة من الخارج، سواءً كإيرادات تصدير للموارد الأولية ومصادر الطاقة، أو الموارد السياحية وتحويلات العاملين في الخارج، أو حتى تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات التصدير.
إن الصعوبات الاقتصادية العالمية تعطل سلاسل الإمدادات، وتخفض الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وعلى رأسها النفط والغاز. وبينما يتوقع تراجع الإيرادات النفطية العالمية بنحو 40% عام 2020، أو ما تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، وفق تقديرات "ريستاد إنرجي"؛ فإن الإيرادات النفطية لدول المنطقة تتوقع أن تنخفض بدورها بنحو 220 مليار دولار. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الموازنات الحكومية ستتحمل 80% من هذا التراجع، بينما تتحمل الشركات النفطية 20%، وهذا يعني أن الموازنات الحكومية بالمنطقة ستخسر نحو 176 مليار دولار من الإيرادات النفطية.
وبينما تمثل تحويلات العاملين مصدر إيرادات مهم لبعض دول المنطقة؛ فإن الضغوط التي تعيشها الشركات حول العالم، تدفعها إلى تسريح الأيدي العاملة، وسيؤدي ذلك إلى تقليص تحويلات العاملين حول العالم بنحو 110 مليارات دولار، أو بنسبة تبلغ 19.8% عام 2020. وبالنسبة للمنطقة، فإن تحويلات العاملين الوافدة لدولها ستتقلص بنسبة 19.6%، لتخسر اقتصادات المنطقة نحو 12.5 مليار دولار من هذا البند في عام 2020 فقط، ومع استمرار الأزمة وتعمق آثارها على أسواق العمل الدولية، فقد تتوسع هذه الخسائر.
وفي الوقت الذي كانت إيرادات السياحة بمنطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 122 مليار دولار في سنوات ما قبل كورونا، فإن هذه الأزمة ستقلص حركة السياحة وإيراداتها بنسبة 80% هذا العام، وفق تقديرات منظمة السياحة العالمية، وبينما سيخسر العالم جراء ذلك ما يتراوح بين 850 مليار دولار و1.1 تريليون دولار، فإن المنطقة ستخسر من هذا البند نحو 97.6 مليار دولار، ما يعني تراجع إيراداتها السياحية هذا العام إلى 24.2 مليار دولار فقط.
وبالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تراجعها بنحو 100 مليار دولار خلال الأزمة، وهذا المقدار يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، كما أنه يزيد عن مجمل تدفقات الاستثمار التي وردت إليها في عام 2019 بأكمله.
يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال، التراجع المتوقع في إيرادات التصدير بالنسبة لدول المنطقة. فبينما بلغت القيمة الإجمالية لصادراتها عام 2019، نحو 968.1 مليار دولار، فإن تحقق السيناريو الأسوأ، الذي تفترضه منظمة التجارة العالمية، والذي يرجّح تراجع التجارة الخارجية بنسبة 32% بسبب الأزمة؛ هو أن دول المنطقة مرشحة لخسارة نحو 309.8 مليارات دولار من إيرادات التصدير هذا العام.
وبذلك، فإن الخسائر الإجمالية لدول منطقة الشرق الأوسط، من جميع البنود السابقة (إيرادات النفط، وتحويلات العاملين، وتدفقات الاستثمار، وإيرادات السياحة والتصدير)، تبلغ نحو 739.7 مليار دولار. وبإضافة الخسائر المتوقعة في القيمة المضافة لدول المنطقة، من خلال انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 4.2% هذا العام، وفق تقديرات البنك الدولي؛ فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية لدول المنطقة، خلال العام الجاري فقط، ستتخطى 900 مليار دولار، وقد تصل إلى تريليون دولار. وبالتأكيد هي مرشحة للزيادة في حال استمرار الأزمة لما بعد 2020، الأمر الذي سيثقل كاهل اقتصادات المنطقة، ويلزم الحكومات باتخاذ قرارات تُساعدها على التعايش مع الأزمة.
سبل التعايش مع الأزمة:
إذا كانت صعوبة التعامل مع الأزمة الراهنة، تكمن في أن معظم العوامل المحركة لها نابعة من الخارج، وبالتالي فليست للحكومات سيطرة عليها؛ فإن ما بيد الحكومات يصبح هو أخذ تلك العوامل كمعطى خارجي، وتدنية التكاليف والخسائر الناتجة عنها، أو بمعنى أدق التعايش معها.
وأول ما يجب على حكومات المنطقة السعي إليه لتحقيق ذلك، يتمثل في إعادة النظر في ترتيب أولويات الإنفاق، وتخفيض أو تأجيل أو إلغاء المصروفات غير الأساسية. وتزداد أهمية هذا الخيار بشكل جوهري بالنسبة للدول ذات الحيز المالي الضيق، والتي تعاني ارتفاعًا في معدلات الديون، واحتياجات تمويلية كبيرة.
وينبغي أن تعمل البنوك المركزية على توفير السيولة للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تقدم قروضًا للشركات الخاصة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، فهي ذات ملاءة مالية ضعيفة وقدرة متدنية على الوصول إلى التمويل، بينما تلعب دورًا حيويًّا في تشغيل الأيدي العاملة، وتوليد القيمة المضافة والدخل، ومن ثم المحافظة على وتيرة الإنتاج والاستهلاك. ويمكن في هذا الإطار اللجوء إلى إلغاء بعض الديون المستحقة على تلك الشركات، ويمكن كذلك تحمل نسب من أجور العاملين فيها، عبر صناديق حكومية يتم تدشينها خصيصًا لتلك الأغراض.
ومن الضرورة بمكان تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها، وأن تسمح البلدان ذات نظم سعر الصرف المرنة، ومعدلات التضخم المنخفضة، بتعديل أسعار الصرف، للمساعدة في احتواء الصدمة الناتجة عن تراجع الطلب الخارجي، وانخفاض إيرادات التصدير. كما قد يستلزم الأمر تشديد السياسات النقدية، والتدخل في أسواق الصرف، لاحتواء الأثر المحتمل لخروج رؤوس الأموال، والتأثير التضخمي لتحركات أسعار الصرف.
وبالنسبة لحالة الدول التي لديها احتياجات كبيرة للتمويل الخارجي، فلا ينبغي أن تتوسع حكومات تلك الدول في الاقتراض بشكل غير مدروس؛ بل هناك أهمية كبيرة لعدم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي قبل استنفاد كل سبل ضبط الإنفاق العام وزيادة فعاليته، وسبل توليد الإيرادات المحلية، ناهيك عن سد الثغرات التي تتسرب من خلالها الأموال من دون طائل، كممارسات الفساد المالي ببعض البلدان.
وبالنسبة للدول التي يتوافر لديها الحيز اللازم أمام السياسات، وخصوصًا التي لديها احتياطيات مالية جيدة، فينبغي تطبيق مزيج من السياسات الموجهة، عبر تقديم دعم السيولة اللازم للقطاعات والمجموعات المتضررة بشدة، كتقديم التحويلات النقدية المباشرة، ومنح تخفيضات موجهة في الرسوم والضرائب. وقد يتطلب الأمر إلغاء الضرائب كليًّا، كإجراء مؤقت، لا سيما وأن معظم نظم الضرائب المطبقة في المنطقة تسمح بنقل عبء الضريبة كاملًا إلى المستهلك، بدون تحمل الشركات أي أعباء، وهذا الأمر يقلل من فاعلية الطلب الاستهلاكي، ويقلص هوامش النمو، ويدفع الاقتصاد نحو مرحلة كساد ممتد.
وينبغي أن يكون لدعم القطاع الخاص مرتبة متقدمة، ودائمة أيضًا، ضمن أولويات عمل الحكومات، عبر تبني مزيج من عمليات إنقاذ الشركات، وتخفيف شروط الائتمان، وإلغاء أو تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم، بما يساعد الشركات في النجاة من نقص الدخل، والحيلولة دون تسريح العمال بشكل جماعي. وهنا يبرز دور صناديق الثروة السيادية، التي يمكن أن تضطلع بمسؤولية حيوية في تخفيف ضائقة الشركات، والمشاركة في إنقاذها، سواء عبر الاستحواذ عليها، أو الدخول في شراكات معها، مع مراعاة ألّا يكون ذلك على حساب قواعد المنافسة في السوق.