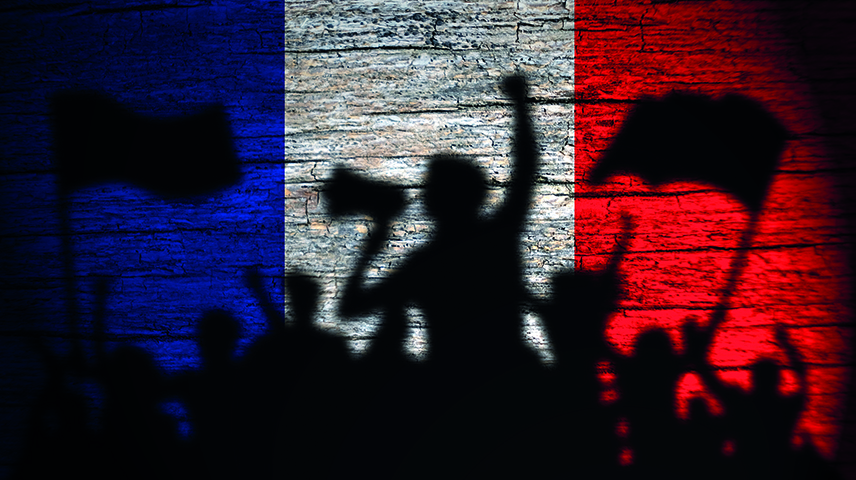تشهد فرنسا موجة من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف على مدار الأيام الماضية، وذلك على خلفية مقتل شاب من أصول جزائرية يُدعى "نائل" على يد أفراد من الشرطة الفرنسية. وامتدت الاحتجاجات لتشمل ضاحية نانتير وغيرها من الضواحي والأحياء في باريس وليون وليل وروان ونيس وغيرها من المدن الفرنسية، التي تقطنها أجيال من مهاجري شمال إفريقيا، وهو ما أعاد مشكلة الضواحي إلى الواجهة من جديد.
وتتكرر مشكلة الضواحي في فرنسا بين حين وآخر، في سيناريو يكاد يكون معروفاً سلفاً؛ طلب أوراق الهوية والتحقق منها، يصاحبه خوف الشباب من البوليس وعدم إطاعة الأمر ثم إطلاق النار على الضحية، وسرعان ما تنفجر الاحتجاجات ويمتد العنف إلى المباني العامة والمتاجر والشوارع.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، أدان معظم الفرنسيين بشكل قاطع إطلاق النار على الضحية "نائل"، واستنكروا تصرف رجل الأمن، وتعاطفوا مع أهل الضحية، لكن بمرور الوقت ومشاهدة أعمال العنف والإحراق واقتحام المقرات الحكومية وإشعال النار في السيارات، تراجع التعاطف مع المحتجين.
مشكلة الضواحي:
يرجع تاريخ نشأة الضواحي بالذات تلك التي تخص المهاجرين من دول شمال إفريقيا (الجزائر وتونس والمغرب) وغيرها من الدول الإفريقية، إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبناء فرنسا وتعميرها، واستقدام العمال من الدول العربية والإفريقية التي كانت تستعمرها فرنسا في ذلك الوقت. وقامت الحكومات الفرنسية ببناء أحياء لإسكان هؤلاء العمال، ومنذ ذلك التاريخ وبمرور الزمن، صار هناك أجيال من المهاجرين الذين ولدوا في فرنسا، وحصلوا على الجنسية وعاشوا حياتهم كفرنسيين.
وتُثار مشكلة الضواحي سواءً حول باريس أو ليون أو المدن الفرنسية الأخرى، منذ ما يزيد عن 30 عاماً، من خلال كتابات عديدة لمتخصصين في هذه المشكلة، وحرصت هذه الكتابات على توصيفها بأنها مشكلة اجتماعية تُجسد اللامساواة الاجتماعية وأبعادها ونمط الحياة والثقافة في الفضاء الاجتماعي.
ومهما تعددت وتنوعت المفردات التي تشير إلى تلك الظاهرة، مثل العنصرية أو المهاجرين أو البطالة أو السكن أو العنف الحضري أو الطبقات الشعبية أو الثقافة المدنية أو "سياسة المدينة"، ثمة قاسم مشترك بينها جميعاً يشكل جزءاً لا يتجزأ من معانيها؛ ألا وهو المواطنون من أصول مهاجرة.
وتتضمن مشكلة الضواحي أو الهجرة والمهاجرين من أصول مختلفة جانبين: أولهما واقعي يشير إلى البطالة وانخفاض الدخل وضعف التعليم والتهميش والفقر، أي المكونات الحقيقية للمشكلة. أما الجانب الثاني فيتلخص في النظرة الخاصة التي يشكلها المجتمع الفرنسي عن تلك المشكلة؛ أي النظرة الأخلاقية والصورة العقلية والاجتماعية والسياسية. وليس من الممكن الفصل بين هذين البعدين، فهما متداخلان بشكل دائم ومستمر، بحيث يمكن القول إنه إذا كان سكان هذه المناطق والأحياء يعانون من مشكلات، فهم في نفس الوقت يُمثلون مشكلة من وجهة نظر المجتمع الفرنسي.
شبح احتجاجات 2005:
استدعت أحداث نانتير ومختلف الضواحي والأحياء التي تشهد الاحتجاجات المستمرة منذ يوم 26 يونيو 2023، من الذاكرة تلك الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا من قبل في عام 2005، عندما تدخلت الشرطة حينها إثر إبلاغ عن الاشتباه بوقوع جريمة سرقة وفرار ثلاثة من الشبان من إجراءات التحقق الأمنية، واختباء ثلاثتهم في محول كهربائي تابع لشركة الكهرباء الفرنسية، فقُتل منهم اثنان على الفور وأُصيب الثالث إصابات بالغة، وتم توجيه تهمة "عدم مساعدة شخص في خطر" إلى اثنين من رجال الشرطة. وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن، واستمرت لمدة ثلاثة أسابيع. وكان الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وزيراً للداخلية آنذاك، وقال تعليقاً على الأحداث: "من ليس لديه شيء يخفيه، لا يخاف من الشرطة".
وخلال تلك الاحتجاجات، ونظراً لاستمرارها لمدة ثلاثة أسابيع واتساعها الجغرافي، اضطرت الحكومة الفرنسية آنذاك لإعلان حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ حرب الجزائر، بعد أن امتدت الاحتجاجات إلى 274 حياً من ليل إلى ليون وتولوز ومارسيليا، وبلغ حصاد هذه المواجهات تدمير نحو 10 آلاف سيارة، وامتداد الحرائق إلى 200 مبنى حكومي، وبلغت جملة الخسائر 160 مليون يورو، وفق تقرير شركات التأمين.
أزمات متداخلة:
لا تأتي الأزمات فرادى في بعض الأحيان، حيث إن أحداث الضواحي الحالية بعد مقتل الشاب "نائل"، قد نشبت بعد عدة أزمات تعاقبت على فرنسا خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تزال ماثلة في ذاكرة الفرنسيين، وأدت إلى خلق بيئة محتقنة. وأولى هذه الأزمات هي "السترات الصفراء"، التي استمرت ما يقرب من العام وشملت أبناء المناطق النائية والريفية البعيدة عن العاصمة، التي تعاني من أزمات شح المخصصات المالية في التعليم والصحة والخدمات العامة، نتيجة السياسات النيوليبرالية التي تعتمدها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. وصاحب هذه الأزمة عنف متبادل من الشرطة والمتظاهرين، وكشفت عن ضعف وتآكل الهياكل النقابية التي كانت تؤطر المظاهرات في وقت سابق، كما أن هذه الاحتجاجات لم ينتمِ أصحابها إلى اليمين أو اليسار، ولم تنتهِ إلا مع بداية أزمة انتشار وباء "كورونا" التي ترتب عليها الإغلاق وتوقف الأنشطة التجارية للمحال والأسواق، وفرضت ضغوطاً على النظام الصحي في فرنسا، فضلاً عن تمرد بعض الفئات على التطعيم وإجراءات الإغلاق.
وما أن تماثلت فرنسا للتعافي من الوباء كبقية دول العالم، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وترتب عليها ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والمحروقات والمنتجات الغذائية وارتفاع معدلات التضخم، في ظل إسهام فرنسا والاتحاد الأوروبي في تمويل هذه الحرب وفرض حزم العقوبات على موسكو والاستغناء عن الوقود الروسي. وأعقب ذلك، أزمة قانون التقاعد الذي تم إقراره دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي).
ويمكن القول إن أزمة الضواحي الحالية لا تقتصر فقط على الضواحي ومشكلاتها المتمثلة في البطالة والفقر، وفشل سياسة الاندماج و"سياسة المدينة" التي اتبعتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة والهادفة إلى تحديث الأحياء الشعبية وتحسين أوضاع سكانها، واستعانت فيها بالعديد من المتخصصين والمستشرقين لوضع ملامحها؛ لأن ما يخص هذه الضواحي يخص أيضاً بدرجات متفاوتة العديد من فئات الفرنسيين في مناطق مختلفة. كما أن صعود اليمين المتطرف وخطاب الكراهية للأجانب أثّر في المواقف التقليدية للأحزاب اليمينية واليسارية وخلق مساحة للتوافق الوطني حول هذه القضية وإن كان بدرجات متفاوتة. بيد أن الضواحي أو سكانها من المهاجرين وأبنائهم يعانون من الإحساس بالتهميش سواءً في التمثيل أو في الوظائف ويشعرون في قرارة أنفسهم بتحيز الشرطة ضدهم، واستخدامها أحكاماً مسبقة عليهم وضد سلوكهم. كما أنهم يفتقدون الثقة في أن مؤسسات الدولة تأخذ همومهم ومشكلاتهم على محمل الجد، والدليل على ذلك هو إعادة إنتاج مثل هذه الأزمات دون إصلاح حقيقي يأخذ مجراه في إطار علاقة هؤلاء بالدولة الفرنسية وأجهزتها.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى نتائج بعض استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حوالي نصف المسلمين في فرنسا يعانون من التمييز، بالرغم من أن الدولة الفرنسية والمحليات والمناطق قامت بتسهيل إقامة دور عبادة إسلامية بالمئات في مختلف المناطق.
ويبدو أن المشكلة الأكبر التي تواجه كلاً من المسلمين والمهاجرين مع الدولة الفرنسية، هي فقدان الثقة بين الجانبين، والانحيازات المُسبقة الكامنة في وعي الطرفين. فالمسلمون في فرنسا تختزن ذاكرتهم فظائع الاستعمار الفرنسي التي ارتكبها في حق بلدانهم بالذات في دول المغرب العربي، أما الدولة والمجتمع في فرنسا فثمة بعض الانحيازات ضد المهاجرين والمسلمين بناءً على الصور النمطية والاستشراقية المترسبة في بعض المؤسسات الفرنسية، مثل اتهام المسلمين بالعنف ورفضهم الاندماج والقيم العصرية والجمهورية وتحدي قيم المجتمع الفرنسي. وربما يفسر ذلك عجز المؤسسات الفرنسية التي أنشأتها الدولة والدوائر الرسمية المعنية بشؤون الديانة الإسلامية، عن ابتكار حلول تحظى بالقبول من جانب الأطراف المختلفة.
تدابير مطلوبة:
الخطوة الأولى على طريق تصحيح هذه العلاقة بين المهاجرين والدولة الفرنسية قد تكون محاولة بناء الثقة بين الطرفين من خلال تبني برنامج وطني لمناهضة العنصرية ضد الأجانب بمشاركة المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والناشطين من المسلمين وغير المسلمين، وإدارة النقاش حول هذه القضية من جماعات الضغط المختلفة من أقصى اليمين وغيرها من الجماعات. كما ينبغي اتخاذ العديد من التدابير التي تخص قوى الأمن والشرطة بعد تراكم الخبرات التي يُفترض أن تستخلصها الإدارة الفرنسية من هذه الاحتجاجات، حيث يمكن مراجعة إجراءات التحقق من الهوية؛ لأنها تنطوي على العديد من الانتهاكات والتعديات اللفظية، كما أنها تستند بصفة أساسية إلى الانتماء العرقي واللون والربط بين الاشتباه وبين الملامح الفيزيقية للشخص.
ومن الأهمية بمكان مراجعة التعديل القانوني الذي يقضي بالسماح لرجال الشرطة بإطلاق النار واستخدام السلاح، وهو التعديل الذي تم إقراره في عام 2017 بحجة الدفاع عن النفس والذي أفضى - كما ذهب باحثون فرنسيون - إلى أن حوادث إطلاق النار القاتلة ضد المركبات قد زادت بمقدار خمسة أضعاف، وقُتل في العام الماضي 13 شخصاً بالرصاص في سياراتهم وغالبية الضحايا من ذوي البشرة السوداء أو أصول عربية.
في هذا السياق، يمكن أيضاً إعادة تأهيل رجال الشرطة المرشحين للعمل في الضواحي والأحياء التي يقطنها المهاجرون، وتزويدهم بمعارف وثقافة عامة إنسانية وأخلاقية تناقض معارفهم المسبقة عن هذه المناطق وتؤهلهم للتعامل معها بطرق مختلفة، حيث إن هذه الاحتجاجات في الغالب تترتب على سلوك الشرطة وإطلاق النار ولا يجد هؤلاء السكان طرقاً أخرى لإسماع صوتهم سوى الاحتجاج.
الخلاصة أن المقاربات الأمنية وحدها لا تكفي لمعالجة قضايا ذات طابع سياسي واجتماعي تتعلق بطبيعة البنى الاجتماعية والطبقية وعلاقات القوى، التي تؤطر الجماعات المختلفة من المواطنين، بل على النقيض من ذلك يمكن أن تُفضي هذه المقاربة الأمنية للمشكلات الاجتماعية إلى عسكرة قوات حفظ الأمن؛ أي زيادة تسليحها ودعمها اللوجستي لمواجهة المتظاهرين والاحتجاجات أو تحرير قوات الأمن من قيود وضوابط إطلاق النار، وهو ما حدث في فرنسا طوال هذه الأعوام، وذلك على حساب "سياسة المدينة" وتقليص الفجوة بين المواطنين واستعادة ثقتهم في النظام وقوات الأمن، وهي الإجراءات التي تفتح الأفق لعلاقات سلمية بين الدولة والمواطنين.