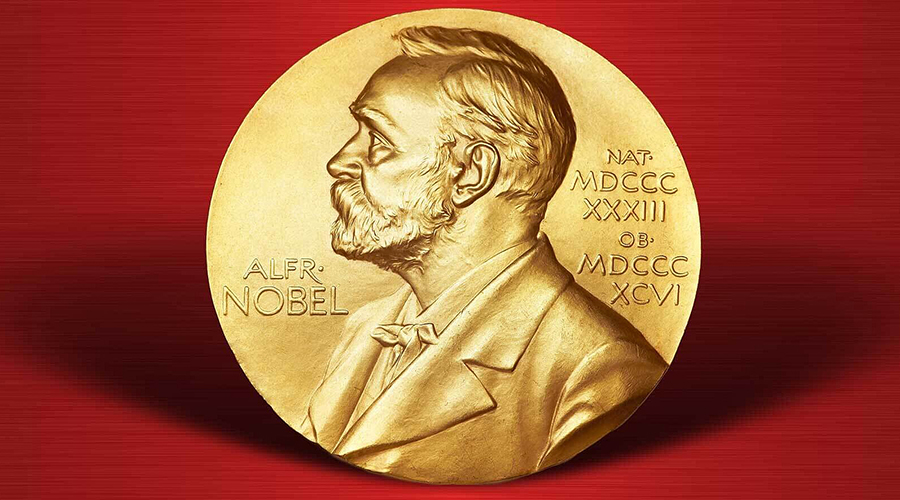لم تخل جائزة نوبل في أي سنة من ريح السياسة وعواصفها، لاسيما في مجالي السلام والآداب، بل إنها تنزع أحياناً إلى التسييس حتى في مجال الاقتصاد والفروع العلمية، فإن لم تفعل هي هذا من تلقاء نفسها، فإن الأخذ والرد الذي يصاحب إعلانها يسحبها إلى ساحات سياسية ظاهرة، حتى بات هذا أمراً معتاداً، وصار جمهور غفير مؤمناً بأن "نوبل مُسيسة" تماماً.
نوبل هذا العام:
لم يكن عام 2021 استثناءً من هذا المسار، إذ أعطت نوبل للسلام مؤشراً على أهمية "حرية التعبير" حين منحت الجائزة لاثنين من الصحفيين هما ماريا ريسا من الفلبين، وديمتري موراتوف من روسيا. وكان هذا لافتاً إلى درجة أن الرئيس الأمريكي، جون بايدن، هنأ الفائزين، وقال إنهما "سعيا وراء كشف الحقائق بلا كلل أو خوف.. وعملا على التحقق من إساءة استخدام السلطة وكشف الفساد والمطالبة بالشفافية، وأظهرا عناداً في تأسيس وسائل إعلامية مستقلة والدفاع عنها ضد القوى التي كانت تسعى لإسكاتهما".
إنها المرة الأولى في تاريخ الجائزة التي تُمنح للصحافة باعتبارها مساراً للدفاع عن السلام، الذي تصنعه الحرية، وتعدد الآراء والاتجاهات داخل المجتمع الواحد، وكذلك الشفافية والمساءلة، وهي قيم مهمة لابد من توافرها في الدولة المعاصرة. وكون الصحافة التي يعمل بها الفائزان هي "الصحافة الاستقصائية"، فإن في هذا انتصاراً لقيمة الدقة والدأب، وأهمية العمل الميداني. لكن نلاحظ أنها لم تُمنح إلى صحفيين يقومون بالأمر نفسه في دول حليفة للغرب، إنما اختيار الفلبين وروسيا لا يخلو من توجه، لأن في البلدين نظامي حكم يناهضان السياسات الغربية، خصوصاً الأمريكية.
ولم تخل جائزة نوبل في الاقتصاد من معنى سياسي أيضاً، فالفائزون بها وهم ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينس، أسهموا في تقديم أفكار عملية مبتكرة حول العمل والهجرة والتربية، بعد أبحاث عميقة قامت على التجريب، وتحليل تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، حيث تبين أن موارد المدارس أهم بكثير مما كان الناس يظنون سابقاً من أجل نجاح التلاميذ لاحقاً في سوق العمل، وأن عاماً دراسياً إضافياً يزيد متوسط الأجور بنسبة 9%. فحكومات الدول، وفي ظل استمرار تأثير جائحة كورونا، في حاجة ماسة إلى اختبار افتراضات تخص العمل والأجور والتعليم والهجرة، لأنها تتقاطع مباشرة مع ما يترتب على انتشار الوباء من نتائج، يخشى الغرب نفسه من تأثيرها على قوته.
معاناة اللاجئين:
أما جائزة نوبل في الأدب فذهابها للتنزاني عبدالرزاق جرنة لم يخل من تسييس، فحيثيات فوزه تبين أنه كاتب اعتنى بقضايا المهاجرين واللاجئين والآثار السيئة للاستعمار، وتناولها، عبر سرده ومصائر أبطال رواياته العشر، دون رتوش، مستفيداً في هذا من تجربته الذاتية، كرجل هاجر أجداده إلى زنجبار، واضطرته حرب أهلية بين العرب والأفارقة في تنزانيا للهروب إلى بريطانيا، بحثاً عن ملاذ، أكمل فيه دراسته، ووجد عملاً كأستاذ للأدب الإنجليزي، ثم كاتب له مكان.
وأثار فوز جرنة شجوناً سياسياً من أكثر من زاوية، فالرجل هو في حد ذاته، ضحية صراع سياسي مرير، حين اندلعت حرب أهلية بين العرب والأفارقة في زنجبار، التي هي مسقط رأسه، قبل ضمها إلى تنزانيا بعد ثورة 1964. فوقتها وجد جرنة، الذي ولد لأسرة ثرية، نفسه مفلساً، وكان عليه أن يترك بلاده مجبراً.
إن الطريق التي سلكها جرنة في صباه صار يسلكها اليوم الملايين من الأفارقة، سواء كانوا يهربون عبر البحر في مراكب الموت، أو يدخلون إلى أوروبا والولايات المتحدة لاجئين شرعيين، أو من خلال تأشيرات سياحية، يستغلون سماحها بالبقاء لوقت محدد بدول أوروبية، في البحث عن عمل هناك. وبعض هؤلاء قد هربوا من الفقر والبطالة، وبعضهم فروا من حروب أهلية طاحنة، أو تغيرات سياسية مفاجئة ومربكة تهدد وجودهم ومستقبلهم.
وقد رأينا في السنوات الأخيرة كيف فر مئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا، وشكلوا معضلة للقارة العجوز، وكيف كان الأفغان يتعلقون بأجنحة طائرات تقلع من مطار كابول ذاهبة إلى الغرب، هرباً من مصائر صعبة تنتظرهم إثر عودة حركة طالبان إلى الحكم. وصنع هؤلاء مشاهد لن تمحى من ذاكرة العالم، وستُلهم أدباء على تصويرها في أعمال سردية قادمة.
وجرنة الذي وصف الهجرة بأنها "ظاهرة العصر" كتب عما يعرفه، كابن أسرة جرفتها حرب أهلية، هي واحدة من حروب وصراعات ترتبت على سياسة استعمارية إنجليزية في القارة السمراء، قامت على مبدأ "فرق تسد"، أو كلاجئ كان عليه أن يواجه معاملة غاية في السوء في إنجلترا بعد أن حل فيها ضيفاً ثقيلاً، حيث يقول هو عما جرى له: "لم أكن لأتوقع كل تلك العدائية التي واجهتها.. تتعرض لكلمات بذيئة ونظرات قبيحة وفظاظة".
إنها العنصرية الصامتة تحت أطمار من المظاهر والكلمات التي تتحدث عن المواساة بين البشر، أياً كانت أعراقهم أو أديانهم أو مذاهبهم أو لغاتهم ولهجاتهم أو الطبقات التي ينتمون إليها والثقافات التي تسكن رؤوسهم. وقد عانى جرنة من هذا الوضع، وصوره في رواياته، وهي مسألة التفتت إليها الأكاديمية السويدية، فذكرت في حيثيات فوزه بنوبل، إنه قد فاز لـ "تعمقه المتعاطف في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات".
صراع الهوية:
هناك وجه سياسي آخر لفوز جرنة تمثل في التنافس حول هويته هو، وعما إذا كانت الجائزة ستُنسب إلى أفريقيا أم العرب أو بريطانيا؛ كونه يسكنها ويكتب باللغة الإنجليزية وليس بالعربية أو السواحيلية. ورأينا كيف كان السجال حول نسب هذه النسخة من جائزة نوبل في الآداب، إلى اليمن أو عُمان قد قام على خطأ يغفل اختلاط الناس في كل الحضارات والدول والحقب. فمثلاً كان العقاد من أصل كردي، وأحمد شوقي من أصل شركسي، ويحيى حقي من أصل تركي، ولو فاز أحدهم بالجائزة كانت ستُنسب إلى مصر التي يحمل جنسيتها.
هذا السجال امتد إلى تنزانيا نفسها، وهي بلد لا يعترف بازدواج الجنسية، فبينما تساءل تنزانيون عن نسبه إليهم، وهو لا يكتب بلغة بلادهم، تمنى كثيرون أن يكون منهم، معولين على أن الأكاديمية السويدية نفسها أعلنت أنه تنزاني، والتسريبات التي سبقت الإعلان قالت إن الجائزة ذاهبة إلى كاتب "عربي أفريقي". أما جرنة فقد حسم الأمر قائلاً: "أنا من زنجبار، لا لبس في ذلك"، ثم أضاف في اليوم التالي اسمه بحروف عربية إلى جانب الإنجليزية في حسابه على "تويتر" الذي لم يكن يتابعه فيه سوى 500 شخص وقت إعلان فوزه بنوبل.
الأهم من كل هذا، أن الأدب الذي كتبه جرنة يدور في ساحل أفريقيا مكاناً، وأسماء أبطال رواياته عربية وأفريقية وهندية، والعوالم التي عبر عنها تنتمي إلى ثقافة هؤلاء. إنه بدا أشبه بألبير قصيري، الكاتب المصري الذي غادر الإسكندرية في شبابه، وعاش في فرنسا حتى بلغ الـ 95، لكنه لم يكتب إلا من الذاكرة عن الإسكندرية التي أحبها وظل الحنين يجرفه إليها، إلى أن توفي في عام 2008. كان يُنظر إلى قصيري طوال الوقت على أنه كاتب مصري، بالرغم من أنه كان يكتب بالفرنسية. والأمر نفسه ينطبق على آسيا جبار (1936 - 2015) الجزائرية التي كانت تكتب بالفرنسية أيضاً، وكانت مرشحة دائمة كجزائرية على قوائم نوبل.
لم يفز قصيري ولا جبار بنوبل، فلم تُطرح هويتهما وتصنيف أدبهما على النحو الذي تم مع جرنة، وهي مسألة لا مانع من تكرارها في قابل السنوات، إذ إن من بين المهاجرين من كل مكان إلى أوروبا وأمريكا أدباءً، وكثيرون منهم يكتبون عن الأشخاص والأيام والأماكن والعوالم التي جاؤوا منها، فيجددون دوماً الحديث عن التعددية الثقافية في المجتمعات الأوروبية، ويطرحون تساؤلات جادة حول مسألة اندماج المهاجرين مع السكان البيض الأصليين.
ربما تراهن أوروبا، التي تعول على القادمين من وراء البحار في تعويض شيخوختها المزمنة، على الجيل الثالث من المهاجرين في اندماج تام، لكن هذه الأمنية تزعزعها دوماً توالي موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب. وقد يزعزعها أيضاً ما يتبقى من آداب وسير ذاتية سردية كتبها الرعيل الأول من المهاجرين، على غرار جرنة، تفضح العنصرية المستترة في المجتمعات الغربية، وتشرح الآثار السيئة للاستعمار، وتكشف عما في فكرة "المركزية الأوروبية" من تصورات استعلائية خاطئة.